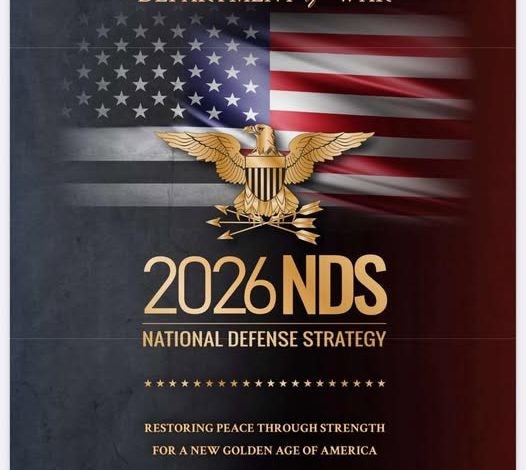
كتب :محمد شهود
نشرت الولايات المتحدة استراتيجية الدفاع الوطني (NDS)، والتي تُعد الوثيقة المسؤولة عن تحويل الرؤية السياسية الأوسع للأمن القومي إلى أولويات عسكرية قابلة للتنفيذ: ما هي التهديدات “الأخطر”، أين تُوزع الموارد والقدرات، وكيف تُعرف مهمات الردع والقتال والشراكات. أهميتها ليست فقط لأنها تنبع من كونها “خطة عمل” للبنتاجون، بل لأنها تكشف أيضا المنطق الحاكم لاستخدام القوة الأميركية: متى تتقدم “الدفاعات الداخلية” على إدارة الأزمات الخارجية، وكيف تُعاد صياغة مفهوم التحالفات، وما الحدود التي تضعها واشنطن لطموحاتها في الخارج.
ولمحبي الخلاصات التي تعنينا في المنطقة فأميركا تقول للحلفاء جميعا: كل واحد يشيل شيلته.. الوثيقة تُعيد ضبط علاقة واشنطن بالحلفاء على قاعدة “تقاسم أعباء أكثر صرامة”: أوروبا مطالَبة بقيادة دفاعها وتمويله بدرجة أكبر، وآسيا تُقدم كأولوية الردع الأولى عبر شبكة شركاء لاحتواء الصين، فيما تُراهن على إسرائيل وشركاء الخليج لقيادة الردع الإقليمي في الشرق الأوسط مع بقاء الدعم الأميركي مشروطًا ومرتبطًا بالمصالح والقدرة.
في نسخة 2026، اللافت أن الاستراتيجية تُقدم نفسها بوصفها قطيعة واعية مع حقبة ما بعد الحرب الباردة التي تصفها بأنها اتسمت بمشاريع “كبيرة/مثالية” مكلفة، وبنزعة لتغيير الأنظمة وبناء الدول بعيدًا عن المصالح المباشرة للأميركيين. بدلاً من ذلك، تُؤسس الوثيقة لمنهج “واقعية عملية” تُعيد ترتيب سلم الأولويات على قاعدة: الأمن الداخلي أولاً، وردع الصين باعتباره التحدي الأشد خطورة على المدى الاستراتيجي، ثم إعادة تعريف دور الحلفاء، وأخيرًا حشد القاعدة الصناعية الدفاعية. 
أول ما يبرز في مضمون الاستراتيجية هو تركيز غير معتاد على “الوطن” ونصف الكرة الغربي بوصفهما مسرحًا أساسيًا للصراع على النفوذ. فهي لا تكتفي بالحديث عن حماية الأراضي الأميركية من التهديدات التقليدية، بل تربط أمن الحدود والهجرة غير النظامية وتدفق المخدرات والجريمة المنظمة بمفهوم الأمن القومي، وتذهب أبعد حين تشير إلى خيارات عسكرية ضد “ناركو-إرهابيين” وتؤكد حماية “تضاريس وممرات حيوية” مثل قناة بنما وجرينلاند و”خليج أميركا”.
في هذا الإطار تطرح الاستراتيجية ما تسميه “المُلحق الترمبي لمبدأ مونرو” كإطار يبرر تشددًا أكبر في فرض النفوذ الأميركي داخل القارة. هذا التحول في الجغرافيا الذهنية للأمن القومي من “العالم كله” إلى “الحيز القريب أولاً”، هو أحد أكثر عناصر الوثيقة تميزًا عن صيغ سابقة كانت تمنح مسارح بعيدة أولوية شبه تلقائية.
ثانيًا، تُعرف الاستراتيجية الصين بوصفها الخصم الأقوى نسبيًا الذي واجهته الولايات المتحدة منذ قرون، لكنها تقترح مقاربة مزدوجة: ردع عبر القوة من دون “مواجهة غير ضرورية”. عمليًا، تركز على بناء “دفاع إنكاري” (Deterrence by denial) على امتداد سلسلة الجزر الأولى في غرب الهادئ، مع توسيع قنوات الاتصال العسكرية لتفادي الانزلاق أو سوء التقدير، وبهدف الوصول إلى “توازن قوى” يسمح بـ“سلام مقبول” بدل تصور صراع صفري أو مشروع لإذلال الصين أو خنقها اقتصاديًا/عسكريًا. الوثيقة بهذا الشكل تعيد رسم الردع ليس باعتباره سباق تصعيد دائم (كما كان يحدث)، بل كإقامة عتبة تمنع الخصم من الاعتقاد بأن الهجوم يمكن أن ينجح. هذا توصيف مختلف في نبرته عن مقاربات سابقة ركزت على “المنافسة الشاملة” أو “الردع المتكامل” عبر شبكات عالمية؛ إذ تمنح الوثيقة 2026 وزنًا أكبر لفكرة: اجعل العدوان مكلفًا وغير قابل للتحقيق، ثم فاوض من موقع قوة.
ثالثًا، تُحدث الاستراتيجية انعطافة واضحة في فلسفة التحالفات وتقاسم الأعباء. فهي تُعلن صراحة أنها ليست “انعزالية”، لكنها تشدد على أن الحلفاء يجب أن يتصرفوا كشركاء لا كـ“تابعين”، وأن عليهم تحمل “المسؤولية الأولى” في مسارح يعتبرونها أكثر التصاقًا بأمنهم من أمن الولايات المتحدة، خاصة أوروبا.
وتستشهد الوثيقة بمعيار إنفاق دفاعي مرتفع (إجمالي 5% من الناتج المحلي وفق تقسيم محدد) وتتعهد بالضغط والتحفيز—بل وبـ“تغيير في النبرة والأسلوب”—لدفع الشركاء نحو التزامات أسرع وأكبر. الجديد هنا ليس فقط مطلب “زيادة الإنفاق” (وهو حاضر منذ سنوات)، بل تحويله إلى محور بنيوي يحدد حجم الدعم الأميركي ودرجته، ويعيد تعريف “التحالف” بوصفه عقدًا مشروطًا بقدرة الطرف الآخر على تمويل دفاعه.
رابعًا، تضع الاستراتيجية “القاعدة الصناعية الدفاعية” في قلب المعادلة، وتتعامل معها كـجبهة حرب بحد ذاتها: إعادة توطين صناعات، زيادة القدرة الإنتاجية، إدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إزالة عوائق تنظيمية، وتوسيع قاعدة الموردين، بل وتتحدث عن “تعبئة وطنية” تشبه موجات تعبئة القرن الماضي. الأهم أن الوثيقة تربط الصناعة بالتحالفات: ليس فقط لتسليح واشنطن، بل لتسريع تسليح الحلفاء أيضًا ورفع قدرتهم على تحمل عبء الردع في مناطقهم. هذه النقلة تجعل “الإنتاج” جزءًا من الردع، لا مجرد ذيل لقرار العمليات العسكرية. 
وعلى مستوى توصيف البيئة الأمنية، تتعامل الوثيقة مع “مشكلة التزامن”، أي احتمال اندلاع أزمات متوازية عبر أكثر من مسرح، بوصفها تحديًا حاسمًا، وتستنتج منه أن قدرة الولايات المتحدة على إدارة أكثر من صراع لا ينبغي أن تقوم على قواتها وحدها، بل على شبكة حلفاء مسلحة وممولة تشكل “محيطًا دفاعيًا” حول أوراسيا. كما تصف روسيا بأنها تهديد “مستمر لكن قابل للإدارة” مقارنة بالصين، وتؤكد الحاجة إلى إعادة معايرة التموضع في أوروبا بما يتسق مع أولوية الردع في الهادئ.
وفي الشرق الأوسط، تبرز لغة تميل إلى تمكين الحلفاء الإقليميين (خصوصًا إسرائيل وشركاء الخليج) لقيادة مهمة ردع إيران ووكلائها، مع احتفاظ واشنطن بخيارات تدخل “محدودة وحاسمة” عند الضرورة.
