سرّ الغضب الصامت وتأثيره:حين يتكلّم ما لا يُقال في اللغة والأدب….بقلم: عماد خالد رحمة _ برلين.
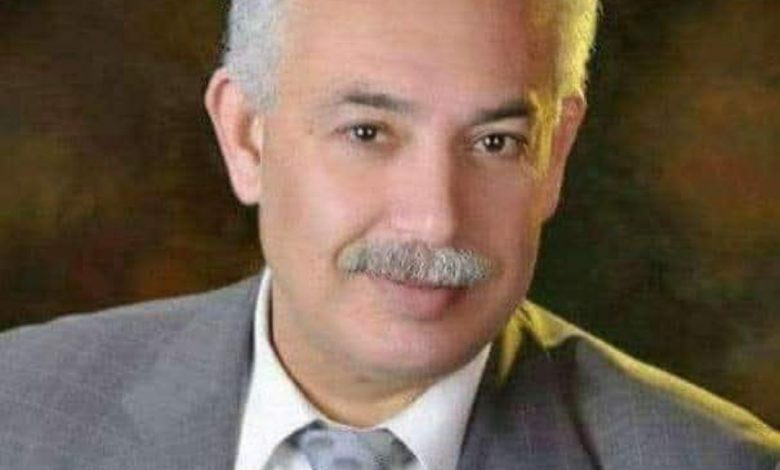
ليس الغضب الصامت مجرّد انفعالٍ مؤجَّل، ولا هو سكونٌ بريءٌ يخلو من الدلالة؛ إنّه لغةٌ مكتومة، وحقلٌ دلاليّ يتغذّى من مفردات الكبت، والتأجيل، والاحتمال، ويُراكم في الحقل المعجميّ ألفاظاً من قبيل: الصمت، الانسحاب، التماسك، القناع، والانكسار المؤجَّل. في هذا التقاطع بين ما يُحسّ وما لا يُفصح عنه، يتشكّل الغضب الصامت بوصفه طاقةً أخلاقية ونفسية ومعرفية، لا تقلّ فتكاً عن الغضب الصاخب، بل لعلّها أشدّ أثراً وأبعد مدى.
يذهب سبينوزا إلى أنّ الانفعالات التي لا تُفهم تُستَعبد صاحبها، لأنّها تعمل في الظلّ، بلا رقابة العقل. والغضب الصامت—بهذا المعنى—انفعالٌ غير مُفكّكٌْ، يتخفّى في هيئة تعقّلٍ زائف، بينما هو في جوهره توتّرٌ دلاليّ بين الإرادة والكلام. إنّه صراعٌ بين حقلين: حقلٍ معجميّ خارجيّ يشي بالاتزان، وحقلٍ دلاليّ داخليّ يعجّ بالاحتراق.
في الأدب، يتجلّى الغضب الصامت بوصفه بلاغة الإيماء لا التصريح. فالصمت—كما يلمّح رولان بارت—ليس نقيض المعنى، بل فائضه؛ إذ حين يعجز اللسان، تتقدّم العلامة الصامتة لتؤدّي وظيفة الدلالة. لذلك نجد الشخصيات الكبرى في الرواية والشعر تُخاصم العالم بصمتٍ كثيف: نظرةٌ منكسرة، انسحابٌ بارد، جملةٌ ناقصة. كلّها إشارات تُحيل إلى غضبٍ يعمل عمله من وراء الستار.
نفسيّاً، يُراكم الغضب الصامت أثره على هيئة تشقّقاتٍ دقيقة في بنية الذات. حيث يرى العديد من علماء النفس أنّ ما لا نواجهه في وعينا يعود إلينا في صورة قدر. والغضب المؤجَّل، حين يُحرم من التفريغ الرمزيّ أو الأخلاقيّ، يتحوّل إلى أعراض: قلقٍ بلا سبب ظاهر، قسوةٍ مفاجئة، أو برودٍ عاطفيّ يُشبه الموت البطيء للعلاقة مع الذات والآخر.
أمّا اجتماعيّاً، فالغضب الصامت هو مادة الأنظمة الرمزية المأزومة؛ إنّه الغضب الذي لا يجد قناةً شرعية للتعبير، فيستقرّ في القاع، حتى إذا ما تراكم، انفجر في لحظةٍ عمياء. هنا يذكّرنا هربرت ماركوزه بأنّ القمع لا يُلغي الرغبة، بل يعيد تشكيلها في صورٍ أكثر تطرّفاً. فالصمت المفروض—سياسيّاً أو ثقافيّاً—لا يُنتج سلاماً، بل يؤسّس لانفجارٍ مؤجَّل.
إنّ تفكيك سرّ الغضب الصامت يقتضي إعادة الاعتبار للغة بوصفها ممارسة تحرّر. فالكلام ليس نقيض الحكمة دائماً، كما أنّ الصمت ليس مرادفاً للرزانة. بينهما مساحة أخلاقية دقيقة، حيث يُمتحن وعي الإنسان بذاته وبالآخر. وحين نُحسن تسمية ما نشعر به، نُقلِّص المسافة بين الحقل المعجميّ والحقل الدلاليّ، ونحوّل الغضب من قوّة هدمٍ صامتة إلى طاقة فهمٍ وتغيير.
هكذا، لا يكون الخلاص في الصراخ، ولا في الصمت، بل في المعنى: أن نقول ما ينبغي قوله، بالقدر الذي يُنقذ الإنسان من احتراقه الداخلي، ويُعيد للغة وظيفتها الأولى—أن تكون جسرًا بين ما نحسّ وما نعيش.
