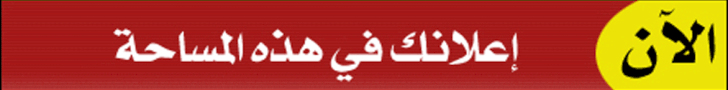قراءة نقدية من إنجاز فاطمة عبدالله لنص( قبضة الريح) للشاعر عادل قاسم

دراسة نقدية من إنجاز: فاطمة عبدالله
النص” قبضة الريح ” الشاعر عادل قاسم
عنوان الدراسة:
“قبضة الريح”: تشظي المعنى وانزياح الذات في أفق الكتابة الشعرية المفتوحة
#تمهيد نظري
ينتمي نص “قبضة الريح” إلى ما يعرف بـ”الكتابة الشعرية المفتوحة” وهي شكل من التعبير الأدبي العابر للنوع، يتقاطع فيه السرد مع الشعر والتأمل الرمزي. وكما يشير “جان كوهن” في أطروحاته حول الانزياح الشعري، فإن مثل هذه النصوص تعتمد على كسر التوقع القرائي، وخلق فضاء لغوي ينفتح على التأويل الرمزي. ويتميز النص بنزعة تفكيكية للواقع من خلال لغة إيحائية تعيد تشكيل الزمن والمكان ضمن سرد غير خطي. هذه البنية الانزياحية تتكئ على التداعي والرمز والتناص مع مرجعيات ثقافية وتراثية (كشخصيات تاريخية و أماكن، وأصوات مغنين شعبيين).
من هنا، تأتي أهمية مقاربة هذا النص عبر تحليل نقدي مركب لتفكيك عناصره التعبيرية، وتبيان مدى ارتباطه بسياقه الثقافي وتمثيله لحالة من القلق الوجودي والتمزق الجمالي في الكتابة العربية المعاصرة….
الاشتغال الأسلوبي: بين التوتر الدلالي والمجاز الشعري
يستند الاشتغال الأسلوبي في نص “قبضة الريح” إلى مبدأ الانزياح بوصفه البؤرة الجمالية التي تميز اللغة الشعرية عن اللغة التداولية، وفق ما نظر له جان كوهن، حيث يتجلى الشعر في خروجه عن البنى المألوفة نحو تشكيلات لغوية تولد دلالات شعورية مركبة.
يبرز ذلك منذ الجملة الافتتاحية: “أُمسكُ بقَبضةِ الريح”، بوصفها تركيباً استعارياً قائماً على استحالة الإدراك الفيزيائي، ما يحوله إلى صورة عبثية تجسد الحرج الوجودي وتستبطن شعور العجز.
وفي عبارة “تبسمتْ غيمةٌ ناهدة”، يتجلى أسلوب التشخيص الإيروتيكي الذي يمنح الطبيعة طابعاً جسدياً أنثوياً ، يضمر بعداً حسياّ ويكشف افتتان الذات بعالم تتداخل فيه الرغبة والارتباك.
كما ينتج النص إيقاعاً داخلياً خفياً من خلال تكرار المفردات (المسك، القلق، النبيذ، المذياع)، ما يسهم في توليد موسيقى نثرية توترية تعزز الشعور بالقلق، وتفعل الوظيفة الشعرية للغة كما حددها رومان جاكوبسون، حيث يصبح الشكل ذاته حاملاً للانفعال والدلالة….
الاشتغال البنيوي: تشكل المعنى وتمفصل البنية السردية
يقارب هذا المحور الاشتغال البنيوي في نص “قبضة الريح”، من خلال تتبع تماسك البنية السردية وتمفصل عناصرها في ضوء العلاقات الداخلية المنتجة للمعنى. فالمنهج البنيوي لا ينظر إلى النص كحامل لمقاصد خارجية (كالمؤلف أو السياق)، بل بوصفه نظاماً لغوياً مغلقاً تتفاعل فيه الوحدات السردية والدلالية عبر شبكة من الوظائف والتضادات والتكرارات البنيوية، مما يتيح تشكل الدلالة من داخل النص ذاته.
وانطلاقاً من هذا التصور، يمثّل تتبّع البنية السردية في النص خطوة أولى لفهم كيفية توليد المعنى داخلياً لا عبر السياق الخارجي. لذا، يمكن استهلال الاشتغال البنيوي بتحليل البنية السردية وتمظهرها الدائري، للكشف عن آليات التشظي والانغلاق داخل الزمن النصي.
تمفصل البنية السردية وتشكلها الدائري
يتحرر النص من تقنيات السرد التقليدي التي تقوم على التسلسل الزمني والسببي، ويعتمد منطق التداعي الحر و”تيار الوعي”، حيث تتتابع الصور والمواقف في إيقاع غير خطي، ينقل تفكك الشعور وتصدع الذات. هذا الشكل من البناء يكرس ما يمكن تسميته بـ”الانفصال عن الحكاية”، إذ لا تبنى الأحداث وفق منطق تصاعدي، بل تتجلى كـوحدات شعورية متجاورة.
يفتتح النص بمشهد شعوري كثيف: “كنت في غاية الحرج، ممسكًا بقبضة الريح”، وينتهي بعبارة مماثلة، في حركة دائرية تكشف عن تمفصل بنيوي يعكس انغلاق التجربة داخل الذات، وتكرار الأزمة لا تجاوزها. وهنا تتجلى البنية الانعكاسية التي تحول الزمن إلى حلقة مغلقة، وتجعل من السرد مرآة للتوتر الوجودي.
دينامية التضاد وتوليد المعنى
يستند النص إلى شبكة من العلاقات التضادية التي تفعل البنية التوترية وتؤسس لتوليد دلالة تتجاوز المعطى المباشر. ومن أبرز هذه العلاقات:
الريح / القبضة: استعارة للصراع بين الإمساك بالمجهول والانفلات، بين الرغبة والسيولة الزائلة.
المسك / القلق: ثنائية تتجاور فيها الحسية والوجد، اللذة والاضطراب، لتنتج طبقة مزدوجة من التوتر.
الغيمة / العاصفة: تحولات الطبيعة بوصفها انعكاساً لانفعالات الذات، من التماهي إلى التهديد.
النبيذ / المذياع: جدل بين الإنفلات الطربي (السكر الرمزي) واليقظة الجمعية (الصوت العام).
هذه الثنائيات لا تعمل بوصفها أضداداً مغلقة، بل تدخل في علاقة تفاعلية تكون ما يسميه “كلود ليفي شتراوس” بـ”المصفوفة الرمزية”، حيث تتداخل التقابلات لتنتج طيفاً دلالياً مفتوحاً تتخلله الانزياحات والاستعارات بوصفها مولدات للمعنى.
لا يسعى النص إلى سرد حكائي، بل ينتج ذاته عبر تراكب الصور وتواشج الانفعالات. فالبنية الدائرية، والتقابلات الرمزية، والانزياحات اللغوية، تعمل مجتمعة على خلق فضاء نصي منغلق شكلياً ، منفتح تأويلياً . وبهذا، يتحقق ما أشار إليه “رولان بارت” بـ”لذة النص” التي تقوم على تفكك المعنى وتعدده داخل البنية ذاتها، لا خارجها….
التحليل الرمزي والأسطوري
يعد المنهج الرمزي / الأسطوري من المناهج التي تركز على كشف البنى العميقة في النصوص، من خلال تتبع الرموز الثقافية و الكونية والتناصات الميثولوجية والتاريخية. ووفقاً لجيلبير دوران وكارل يونغ، فإن الرمز هو صورة مركبة تكثف تجارب جمعية وفردية، وتعبر عن لاوعي ثقافي مشترك.
نص “قبضة الريح” غني بالإشارات الرمزية المتراكبة التي تعمل بوصفها بنى تحتية دلالية، تفتح المعنى على فضاءات الأسطورة والهوية.
الريح: الذات المنفلتة / الزمن / القدر
افتتاحية النص بـ”قبضة الريح” تشكل صورة انزياحية شديدة الكثافة الرمزية؛ فالريح، في الثقافات القديمة، رمز لما لا يقبض أو يسيطر عليه، وهي مرتبطة غالباً بالقدر أو التقلب أو الروح. وفي هذا السياق، تمثل الريح تجسيداً للذات التي تعجز عن الإمساك بمصيرها، فتصبح القبضة فارغة، والوجود محاطاً باللاجدوى أو بالحرج الوجودي.
الربابة: التعلق بالموروث / الفن في مواجهة العدم
استدعاء الربابة، كآلة تراثية، ليس مجرد تذكير بصوت بدوي، بل توظيف رمزي يحيل إلى استمرارية الذاكرة الجماعية وسط عالم مضطرب. توظف الربابة هنا كجسر بين الذات والماضي، وكأن الراوي يجد في هذا الصوت العتيق ملاذاً جمالياً يوازن هشاشة الحاضر.
النابغة: تناص شعري / سؤال دور الشاعر
يحمل حضور “النابغة” تناصاً مع النابغة الذبياني، شاعر البلاط والمعلقات. هذا التناص يفتح النص على ثنائية “الشاعر/السلطة”، ويثير تساؤلاً ضمنياً: هل لا يزال للشاعر صوت في زمن التشظي؟ يحضر “عرف النابغة الذي يشبه عرف الديك” كإشارة سيميائية ساخرة ومركبة، تعيد النظر في مركزية الشعر والبطولة الرمزية في الثقافة العربية.
الكبنچي: الذاكرة الجمعية / الفن المقاوم
يأتي “محمد الكبنجي” – مطرب المقام العراقي – بوصفه رمزاً للصوت الشعبي العميق، وإشارة فنية ترتبط بالمكان والتاريخ والعاطفة الجماعية. يحيل استدعاؤه إلى وظيفة الفن كنوع من المقاومة الجمالية، وكتكثيف لهوية محاصرة تبحث عن نغمة خلاص في وجه “القلق” والانهيار.
اذا كل هذه الرموز تعمل كبنى تحتية متشابكة داخل النص، تعيد تشكيل العلاقة بين الذات والذاكرة، الفرد والجماعة، الماضي والحاضر. وهي لا تظهر بشكل زخرفي، بل تشكل عقداً رمزية تتحكم في حركة المعنى، وتنتج خطاباً شعرياً يزاوج بين الحلم والأسطورة، وبين الاغتراب والانتماء…
الأسطورة والظلال الثقافية
يتغلغل في نسيج النص ما يشبه البنية الطقسية ذات البعد الأسطوري، حيث تتضافر إشارات رمزية وثقافية تستدعي منطق الأسطورة كما صاغه كل من ميرسيا إلياد وجوزيف كامبل، اللذين يؤكدان أن الطقس والأسطورة يعملان كأدوات لاستعادة المعنى وتجديد الزمن المفقود.
في نص “قبضة الريح”، تتخلق هذه البنية عبر مشهديات رمزية تحاكي رحلة روحية تتقاطع مع مفردات التراث والمخيال الشعبي.
مشهدية الصحراء والبحث الطقسي
يقول الشاعر في النص:
“غيرَ آبهٍ بالجيادِ التي تجوبُ الصحراءَ بَحثاً عنْ سُراقة…”
هذا المشهد يفكك مفهوم الرحلة في الزمن الواقعي، ويعيد تأطيرها ضمن بنية أسطورية؛ فالصحراء هنا ليست مجرد فضاء جغرافي، بل مساحة وجودية تحاكي مرحلة التيه أو الابتلاء، تماماً كما هو الحال في الطقوس التطهيرية أو “رحلة البطل” الكامبلية، حيث يجب على الذات أن تجابه محنها الرمزية لتولد من جديد.
وسراقة، بوصفه شخصية تاريخية ترتبط بالمطاردة والهروب، يستدعى في النص لا كشخص، بل كرمز للغائب أو المراوغ، وكأن البحث عن سراقة هو بحث عن المعنى أو الخلاص المؤجل.
الحشود والطقس الجماعي
تتجلى علامات الطقس الشعبي في مشهد تجمهر الصبية حول “أم البْروم”، فيقول النص:
“فَندَبتْ حظَّها مُتَمتِمةً، غَلَبني فُوها ، فتجمهرَ الصبيةُ عَليها…”
وهنا نقرأ إحياء لبنية طقسية شعبية، تنطوي على مفردات الرثاء والنحيب الجماعي، وكأن “أم البْروم” تحاكي “المرأة الطقسية” أو “الأم الجماعية” التي تندب المصير، في حضور شعبي يعيد إنتاج مشهد كربلائي رمزي.
هذا التجمهر لا يفهم فقط بوصفه حركة داخل السرد، بل هو تجسيد لطقس جماعي يعيد إنتاج الحزن كهوية ثقافية، يزاوج بين العام والخاص، الجماعي والذاتي .
رمزية الطفولة و”الصبية”
يظهر “الصبية” كمكون ختامي في الطقس، إذ يمثلون البراءة الجمعية المندهشة أو المُنفعلة تجاه الأحداث، ويُمكن قراءتهم كظل للجيل اللاحق، الذي يحدق في مأساة الأم/الذاكرة من دون قدرة على الفهم الكامل، ما يعيدنا إلى طقس التلقين والتوريث الرمزي.
وهكذا النص، من خلال هذه العناصر (الصحراء، سُراقة، الحشود، أم البروم، الصبية)، يعيد إنتاج بنية الطقس الانتقالي كما في الأساطير، حيث تستحضر قوى الطبيعة والذاكرة والرموز الجمعية لتشكيل مشهد يفيض بالمعنى.
وهكذا يعيد النص تأويل الواقع من خلال أسطرة التفاصيل اليومية، في ما يشبه رحلة عرفانية رمزية تحاكي ما وصفه إلياد بأنه “استعادة الزمن المقدس في لحظة دنيوية”، ليجعل من اللغة طقساً ومن الذاكرة أسطورة، ومن الحكاية سؤالاً مفتوحاً عن المصير…..
البعد الثقافي–السياسي في النص
يندرج نص “قبضة الريح” ضمن ما يمكن مقاربته وفق منظور النقد الثقافي الذي يرى أن النصوص الإبداعية هي مرآة مشوّشة للقلق الجمعي والتحولات المجتمعية، وتعبر عن خطاب مضمر في مواجهة السلطة أو الصدمة أو فقدان الاستقرار، وهو ما تطرحه مقاربات إدوارد سعيد وهومي بابا في الحديث عن الثقافة بوصفها ساحة مقاومة وتأزّم في آن.
بين الكبنچي وأم البروم: تقاطعات الفن والمكان والهوية
يوظف النص مرجعين ثقافيين عميقين:
“الكبنچي” كمطرب مقام عراقي يمثل الهوية الصوتية والانفعالية للفن الشعبي العراقي.
“أم البروم” كمكان واقعي في البصرة، يتحول إلى فضاء دلالي مشحون بالاحتجاج والتشظي.
يقول النص:
“يبثُ أغنيةً، أمان،،أمان،،،يا،،يابة،، للگبنچي،،،فيندلقُ الزقُّ من على رأسِ أُمِّ البْرومِ…”
في هذا المشهد تتقاطع الذاكرة الثقافية (المقام) مع الواقع المأزوم (انسكاب الزقّ في الفضاء العام)، في تحول سردي شديد الرمزية، يمثل انهيار الجمال وسط العجز الشعبي، ويفضح هشاشة الهوية الثقافية في وجه الفقد والانهيار.
هنا، لا يظهر الفن كملاذ، بل كصرخة غير قادرة على إنقاذ الواقع، وكأنما مقام الكبنچي لا يشفي، بل يحرض على الندبة.
ثنائية اللذة والقلق: الطرب كمقاومة وجودية
تحضر في النص ثنائية متوترة بين ما هو لذي وقلق في آن، يقول الشاعر في النص:
“أدور عليهم بدنان الشعر المعتق، فيغرفون المسك، ويعبّون كؤوسهم بالنبيذ والقلق…”
تجسد هذه الصورة مفارقة ثقافية/سيكولوجية: فالنبيذ، بوصفه رمزاً للمتعة أو النشوة، يتجاور مع القلق، وهو ما يعكس الشرخ الداخلي بين الرغبة في الانفلات من الضغط، والوعي المأساوي بالعجز.
الناس في النص ليسوا منتشين حقاً ، بل يشربون القلق مغلفاً بالمسك. وهذا ما يشير إليه تيودور أدورنو في نقده للثقافة الحديثة: حين تصبح المتعة وسيلة لإخفاء الخوف، لا لمواجهته.
الذات الجمعية بعد الفقد: صمت ما بعد الكارثة
يمكن قراءة النص بوصفه كتابة ما بعد الفقد، حيث الذات الجماعية العراقية تتكلم عبر الانزياح والرمز لا عبر التصريح.
يتجسد هذا في جملة:
“وأنا لم أزل في غاية الحرج، ممسكاً بقبضة الريح…”
هذا الحرج المتكرر ليس شعوراً فردياً ، بل هو رمز وجودي /سياسي للتيه الجمعي في ظل انهيار المشروع الثقافي أو الوطني، إذ يمسك الراوي بما لا يمسك، ويظل مشدوداً إلى لحظة الفراغ، بلا مخرج ولا نهاية.
نجد أن النص يحول اليومي و المألوف إلى ما هو سياسي /ثقافي مشحون، إذ يفكك علاقة الفن بالواقع، ويعيد تمثيل الذات العراقية بوصفها ممزقة بين صوت الماضي وانكسار الحاضر، حيث تتجاور اللذة والقلق، الطرب والانهيار، في مشهد سردي / شعري يحيل إلى تمثيلات ما بعد الصدمة في الأدب.
وبذلك، تتحول “قبضة الريح” إلى تجربة جمالية و ثقافية و مركبة، تتكئ على الرمز والذاكرة لتعيد طرح سؤال مقلق: هل ما زال للهوية صوت في زمن الخراب؟
موقع النص في الخارطة الأدبية المعاصرة
يشكل نص “قبضة الريح” نموذجاً أدبياً متقدماً لما بات يعرف بـ”النصوص الشعرية السردية الهجينة”؛ وهي تلك الكتابات التي تتقاطع فيها بنى الشعر مع تقنيات السرد، و تنفتح على البعد الرمزي والثقافي و الأسطوري، ضمن توليفة لغوية مشحونة بالانزياح الدلالي والانفعال الشعوري الكثيف. وقد أفلح النص، من خلال اشتغاله الجمالي و الرمزي في توليد تجربة معرفية وتأويلية متعددة المستويات، تستدعي قارئاً مثقفاً منخرطاً في الأنساق المحلية، و متمكناً من أدوات القراءة الحداثية وما بعدها.
تنبثق القيمة الأدبية للنص من خلال:
كثافته الشعورية المتحققة عبر لغة انزياحية عالية التوتر.
توظيفه الرموز التراثية ضمن أسلوب حداثي ينأى عن التقريرية.
بنية تشظ سردي تعكس ارتباك الذات الفردية والذات الجمعية في سياق ما بعد الفقد والخراب.
وعلى مستوى الانتماء النوعي، يندرج “قبضة الريح” ضمن ما يصطلح عليه بـ”الكتابة العابرة للنوع” (Transgeneric Writing) أو “الشعر السردي”، وهو خطاب يتبنى آليات اللغة الشعرية بوظائف سردية و تأملية وثقافية، ما يجعله نصاً متملصاً من التصنيفات الكلاسيكية.
أما من حيث الانتماء الثقافي و الدلالي، فإن النص يقارب مفاهيم “أدب ما بعد الحرب” و”أدب ما بعد الصدمة”، بما يتضمنه من استدعاء للهويات المهددة، و استبطان للحنين المتشظي واستحضار للأصوات المهمشة في مواجهة الذاكرة الممزقة.
ولا يمنح النص دلالته بسهولة، بل يقيم تجربة مراوغة تتطلب تفكيكاً متعدد الأوجه، مما يؤهله للتموضع في أنطولوجيات تعنى بالكتابة الرمزية، وأدب الهويات الثقافية المتنازعة، والدراسات ما بعد الكولونيالية. كما يوفر نموذجاً تطبيقياً صالحاً لمقاربات النقد الثقافي، ودراسات ما بعد الذاكرة (Post-memory Studies)، خاصة فيما يتعلق بعلاقة النص بالذات الجمعية، والرمز الشعبي بوصفه مكوناً مقاوماً و ناطقاً باسم الجماعة المغيبة…
……
النص :
قَبضةُ الريح
كنتُ في غايةِ الحَرج، مُمسكاً بقَبضةِ الريح ،حينَ لامسَ كَفيَ وجههُ، فتبسمتْ غيمةٌ ناهدة، كانتْ تسيرُ على مَيمَنتي ، أهشُ بعصايَ على ظَهْرِها، الذي عَكَّرتهُ ُالعواصف ، فتناولتُ من حِجْر المُغني ربابته ، وحلَّقْتُ في فَضاءٍ عامرٍ بالوجوه ، أََدورُ عليهم بدِنانِ الشعرِ المُعَتَّق ، فيغْرِفونَ المِسْكَ ، ويعبِّونَ كؤوسَهم بالنبيذ والقَلَق ،لمّا إنبرى النابغةُ بعِرفهِ الذي يشبهُ عِرفَ الدِيك ، غيرَ آبهٍ بالجيادِ التي تجوبُ الصحراءَ بَحثاً عنْ سُراقة ،إِذْ تسارعتْ البِيدِ هَلَعاً تحتَ رحمةِ ظِلِّهِ الطائر، بَيدَ أنَّ مابددَ وخشةَ السفرِ المَيمونِ ،صوتُ المِذياعِ،يبثُ أغنيةً، أَمان،،أَمان،،،،،يا،،يابة،، للگبنچي*،فيندلقُ الزِقُّ
من على رأسِِ أُمِّ البْرومِ* فَندَبتْ حظَّها مُتَمتِمةً، غَلَبني فُوها ، فتجمهرَ الصبيةُ عَليها، وأنا لمْ أزلْ في غايةِ الحَرج مُمْسِكاً بقَبْضةِالريح،
*الكبنچي- هو محمد الگبنچي رائد ومطرب المقام العراقي الشهير
*-ساحة من ساحات مدينة البصرة