تطبيق المنهج البنيوي على الأدب: قراءة في أصوله وتطوره ومؤثراته… بقلم: عماد خالد رحمةـ برلين.
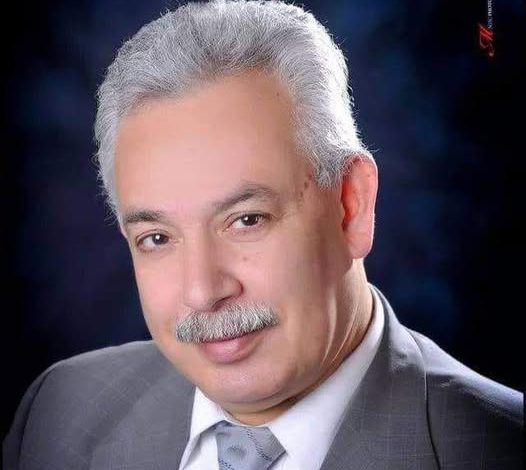
لقد شكّل المنهج البنيوي ثورة فكرية في حقل الدراسات الأدبية، إذ أسهم في إعادة النظر إلى النص الأدبي ككيان متكامل يُدرس وفق بنيته الداخلية، بعيدًا عن الاعتبارات الزمنية أو السردية أو النفسية للمبدع. وقد دلّت القراءات الدقيقة على أن التطبيق الأولي لهذا المنهج على الأدب قد ظهر في منتصف خمسينيات القرن العشرين على يد علم اللغويات الروسي رومان أوسيبوفيتش جاكبسون، الذي تناول النص الشعري بوصفه نظامًا لغويًا مستقلًا، يسري عليه منطق التحليل البنيوي ذاته الذي يُطبَّق على اللغة. وقد رافقه في هذه المسيرة الرائد الفرنسي كلود ليفي شتراوس، الذي وظف المنهج البنيوي في دراسة الأسطورة والسرد، مكشوفًا عن أنماط متكررة وقوانين تركيبية تحكم البنية الرمزية للنصوص.
ومن أشهر التطبيقات النقدية المبكرة للمنهج البنيوي كانت على قصيدة “القطط” للشاعر الفرنسي الرمزي شارل بودلير، حيث أظهر التحليل كيف تتشابك العناصر الصوتية والدلالية والرمزية لتصوغ تجربة جمالية متكاملة. لم يتوقف البنيويون عند النصوص الشعرية فحسب، بل امتدوا إلى السرديات، إذ عمد الشكلانيون الروس مثل شكلوفسكي، فلاديمير بروب، وتوماشفسكي إلى تفكيك الرواية والحكاية إلى وحداتها البنائية، مستكشفين قوانين التشكل الداخلي التي تتيح للنص أن يكون نصًا بمعزل عن خبرة القارئ أو سياق التأليف.
لاحقًا، جاء البنيويون الفرنسيون، ومن أبرزهم جيرار جنيت، كلود بريمون، وتودوروف، ليعيدوا صياغة الأدب ضمن شبكة علاقات متشابكة بين الشكل والمضمون، حيث لم يعد النص مجرد حكاية تُروى، بل أصبح نظامًا من العلامات يُمكن دراسته وتحليله وفق قوانين نحوية وسيميائية خاصة به. وقد وسع هذا التطور أفق النقد الأدبي، فأصبح ممكنًا فهم النصوص من منظور أنساقها الداخلية قبل أي اعتبار خارجي، مظهرًا وحدة بنيوية دقيقة تتجلى فيها الإيقاعات والدلالات والرموز.
أما في السياق العربي، فقد تجلّى المنهج البنيوي اللساني بطرائق وأساليب متعددة، حيث وظف نقادنا العرب هذا المنهج لفهم النصوص الشعرية والسردية على حد سواء. ومن أبرز هؤلاء يمنى العيد، حسن بحراوي، عبد العزيز حمودة مؤلف كتاب المرايا المقعَّرة والمرايا المدَّبة، جابر عصفور، عبد الملك مرتاض، ومحمد بنيس، الذين سعوا إلى تفكيك النص العربي إلى وحداته البنيوية، مستفيدين من أدوات التحليل اللغوي والسيميائي. ولم يغفل حسين الواد، عبد الله الغذامي، خالدة سعيد، عبد الفتاح كليطو، وسيزا قاسم عن استلهام البنية البنيوية للكشف عن رمزية النص، والأنماط المتكررة، والبنى العميقة التي تهيمن على النص العربي الكلاسيكي والمعاصر على حد سواء.
إن المنهج البنيوي، بهذا المعنى، لم يكن مجرد أسلوب تحليل، بل تحول إلى فلسفة نقدية كاملة، تمنح القارئ والمحلل أفقًا فريدًا لفهم النص الأدبي على أنه نظام متكامل من العلامات والوظائف والأنساق، حيث يُكشف القانون الجمالي الداخلي للنص، وتتجلى العلاقة العضوية بين الشكل والمضمون، بين الصوت والدلالة، بين الرمز والمعنى. وهو بذلك يفتح أبوابًا جديدة لإعادة قراءة التراث الأدبي وفهم النصوص الحديثة، بعيدًا عن الانطباعات السطحية أو التأويلات العاطفية، متمثلًا في رؤية نقدية علمية دقيقة تُعيد الاعتبار للنص باعتباره كيانًا قائماً بذاته.
وفي النهاية، يمكن القول إن تطبيق المنهج البنيوي على الأدب لم يكن مجرد حدث أكاديمي أو تقنية تحليلية، بل كان تحوّلًا معرفيًا جذريًا يُعيد تعريف النص الأدبي، ويضعه في قلب تجربة جمالية محكومة بالبنية، حيث كل كلمة، وكل جملة، وكل رمز، وكل صمت داخل النص، لها دورها في تكوين النظام الكلي، فتكتمل الدائرة بين المؤلف، والنص، والقارئ، في تجربة نقدية منهجية تكشف العمق البنيوي للمعنى والجمال معًا.
